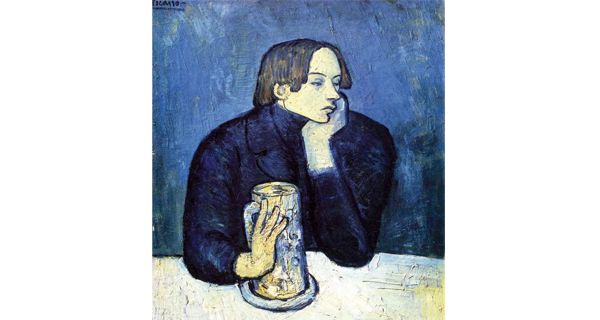
ما أهمية أن يحظى الشعر بيوم عالمي خاص به، في زمن يزيد فيه عدد الشعراء ويقل عدد القراء، ويتراجع الشعر لتتقدم الرواية؟. الشعر تلك «النار المجمدة»، كما يصفه كوكتو، هل مازال قادرا على إشعال حريق الأسئلة و«تغيير الحياة» بحسب قول رامبو؟. اليونيسكو، وهي تحتفي بالشعر كل عام، ترى أننا نحتاج إلى قوة الشعر في الأوقات التي يكتنفها الغموض والاضطراب أكثر من أي وقت مضى، وتتحدث عن أهميته لإقامة أشكال حوار جديدة بغية تنمية القدرات الإبداعية التي تحتاج إليها كل المجتمعات في الوقت الراهن، كما قالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونيسكو في كلمتها في يوم الشعر العام الماضي. ولكن الشعراء وهم يكتبون كلماتهم لهذا اليوم، هل يحتفون بالشعر أم يرثونه؟!
وديع سعادة (شاعر لبناني):
بالتأكيد لن يغيّر الشعر شيئاً في هذا العالم الذاهب إلى حتفه والذي يحفر قبره بيده. لكن، مع ذلك، على الشعر أن يبقى يقارع هذا العالم وأن يدينه، ليس وهماً بتغيير، بل على الأقل كي يحافظ الشعر على براءته مما يجري في العالم من قتل، جسديّ وروحيّ، للبشرية وللإنسانية. بات الشعر في آخر اهتمامات الناس، وهذا لا يعني فقط أن الأدب بات في آخر الاهتمامات، بل يعني في الدرجة الأولى أن الروح الإنسانية، والجمال والحق والخير والقيم، باتت آخر اهتمامات البشر. يوم عالمي في السنة للشعر، و 365 يوماً قتلٌ عالميّ للإنسان! حلمُ الشعراء بات وهما. لكن رغم ذلك على الشعراء أن يحافظوا على هذا الوهم كي يحافظوا على الجمال ولو وهميّاً. صحيحٌ أن هذا العالم لم يعد الشعر يجدي فيه، لكن وهْمَ الشعراء يبقى فيه هو الجمال الوحيد.
حسين آل دهيم (شاعر سعودي):
منذ نشأة الحياة على هذه الأرض وتطور الألسن البشرية وابتكارها لطرق وآليات للتواصل فيما بينها، بات العنصر البشري أكثر التصاقاً بالجماليات التعبيرية بدءاً من السيميائيات البصرية وصولاً للسيميائيات اللغوية، الإنسان بفضل هذه المقدرة على انجاز صيغ تعبيرية بامتلاكه لكائن لغوي يتطور بمحاذاته، وربما بوتيرة أسرع لما تمتلكه اللغة من قابلية مرنة ومطواعة للتحول الوظيفي.
هذا ما يجعل اللغة شاعرية في عمقها والإنسان، حامل هذه اللغة ومنتجها، شاعراً في كل حالاته مهما اختلف لسانه وموقعه وتعاطيه مع الكائنات والأشياء من حوله، بسبب طرق التفكير في العلاقة بينه وبين الموجودات، على اعتبار أن هذه الموجودات مسببات ايحائية له، والشعر بطبعه كائن إيحائي يعمل على هندسة أبنية من لغة متجاوزة ومتفلتة من قيود الوظائف المعتادة للغة، الشعر بلغته التي تقف موقف الدم في العروق سيالاً متدفقاً ويصنع المعجزات. أليس حرياً بنا أن نفخر بهذا المنجز الإنساني؟
في ظني ان الشعر هو المنجز الذي يجب أن تتباهى الإنسانية الحقة به، لا شيء يشبه الإنسانية في عظمتها وقدرتها على خلق الجمال أكثر من الشعر، الشعر في كل تناقضاته المذهلة وقدرته على فضح القبح في كل ركن من أركان الحياة، الشعر الذي بقي منذ ولادته على أول لسان فذاً متجدداً عابراً للزمان، عصياً على التعريف والتأطير، تكمن عظمته في توالده وانحيازه للنبع واغفاله المجرى، هو الينبوع وما عداه يظل سبخات تبعث على العطش. المجد للشعر والمجد لكل شاعر استشعر عظمة هذا الكائن في نفسه.
حسين حبش (شاعر كردي):
يهمني كشاعر وجود الشعر في كل شيء، في جسد النبات الأخضر، في رزانة الحجر وهدوئه، في قلب عصفور يشاكس الأفق، في قطعة غمام على وشك أن تتحول إلى ذئبة، في مخالب سنجاب يشاغب أغصان الأشجار، في أناقة إوزة تقود صغارها على سطح البحيرة، في لون قوس قزح وهو ينبثق من خلف التلال، في طنين نحلة تطير من زهرة إلى أخرى، في جناح فراشة على وشك الانتحار، في قطرة الندى الغافية على خد وردة، في انبثاق برعم صغير من شق صخرة، في قش يهتز في منقار عصفور، في رشاقة غزالة تسابق الريح.
الشعر، هذا الكائن الباهر يلبس ـ في الوقت نفسه ـ آلاف الألوان، وكلها تناسبه وتأتي على مقاسه تماما. يجسد في نفسه الحلم ونقيضه. وهو ذئب وخروف، وأسد وغزال، وعصفور وأفعى في الوقت نفسه. يبارز الريح ويشد أزر الغيوم. يفك القيد عن معصم الخيال ويدير دفة الغرابة كقبطان متمرس. تغويه المناطق النائية، وينأى بنفسه عن البلادة والسكون. يحيا بأعصاب مشدودة دائما. يتحدث مع الصخور والأحجار كما لو أنه يتحدث مع البشر والأشجار والأعشاب والنباتات. يركض في البراري والدساكر، ويغوص في قلب المدن وعالمها السفلي. صامت مجهول غريب الأطوار، يضع يديه في جيبه ويسير في كل الاتجاهات في الوقت نفسه.
ومع ذلك يُسأل أيضاً ما هو الشعر؟
الشعر هو أن تقنع الآخرين أن الجبال قبعات نائمة وأن الوديان فراسخ الماء!
سيأتي الرد فوراً: هذا مستحيل.
بالضبط، الشعر هو هذا المستحيل.
إذن، العالم قبل الشعر يكون بشكل وبعده يكون بشكل آخر، أي أنه إذا تلبَّس بلبوس الشعر، ينبعث من الرماد إلى النور ومن البلادة إلى الرهافة.
الشعر، هذا الكائن الذي لا يضاهيه أي شيء في الوجود، جعلني شخصياً أضحي من أجله بكل شيء، المقدس منه والمدنس على طريقة جان كوكتو. وبين الحين والحين أناديني: فيا أيها الشاعر الذي فيَّ هل أخلصت لدرس الشعر وضحيتَ لأجله بما يكفي من التضحية والعشق؟ أجيبني: أحاولُ ذلك بكل طاقتي وخلاياي والدم الذي يجري في عروقي!
لا يسعني في الأخير إلا أن أقول لزملائي الشعراء، أعزائي اكتبوا القصائد على سواعدكم، على سيقانكم، على ظهوركم، على أعناقكم، على خدودكم، على بطونكم، على سرركم، على أصابعكم، على صدوركم… فالقصيدة يجب أن تكون ملتصقة باللحم، قريبة من نبضات القلوب، جزءاً من الأنفاس، لصيقة بالروح، دماً يجري في العروق.
رائد وحش (شاعر فلسطيني):
هل مات الشعر؟ ربما! موته نوع آخر من مواصلة الحياة، أعني أنه يتحوّل إلى فن عصي يصعب قياده بالطلاقة الغنائية القديمة، أو بالاكتفاء به كبوح نفسيّ. موته هو تحوله إلى نوع من البحث والتثقف والدراسة، بحيث لا يكتفي بالقصيدة عماداً له، بل بذهابه إلى فضاء الكتاب الشعري بما فيه من شغل ورؤيا وجودية وفكرية. هناك فقط يمكن أن يتحوّل الموت، موت الشعر، إلى أخ شقيق للحياة، ومكمل لها ولمعناها.
يصبح تعاملنا مع الشِّعر أكثر جديةً كلما ابتعدنا عن فضاء الفيسبوك. كائنٌ ميّال إلى الاحتجاب مثله لا يريد إلا الاختباء في مناطق الهَمْس والأسى النائية، ولا يناسبه على الإطلاق أن يكون منصة للخطابة، ذلك أن صفحات التواصل الاجتماعي تتحوّل مع الوقت إلى منابر للخطابة المكتوبة، بما لا يختلف عن الخطابة القديمة إلاّ في الوسيط.
تحويل الشعر إلى كائن اجتماعي قتلٌ متعمّد له، فحيث إن طبيعة الفيسبوك بالذات هي التلصص، سيتحول الشعر الذي ينشره مستخدمو هذا الموقع إلى نوع من قراءات نفسية الشخص الذي ينشره لدى من يتلقونه، أكثر من ذهابهم إلى خيار القراءة الجمالية، فمثلاً؛ لو نشر أحد المستخدمين قصيدة للوركا، سيكون همّ غالبية أصدقائه أو متابعيه هو البحث عن سبب نشره لهذه القصيدة بالذات، وعن الدافع والشعور الذي يعيشه، أي أنهم سيبحثون بكل ما حول النص، دون أن يكون النص نفسه محلَّ اهتمام.
لا شكّ أن فيسبوك لعب دوراً في تسهيل نشر الشعر، وسهولة تواصل الشعراء، والعمل على تشكيل مكتبات شعرية إلكترونية متاحة وسهلة لمن يرغب في القراءة الجادة، لكنه بين كل ذلك غيّب الشعر. كثرته الضّارية قلّةٌ، إن لم نقل انعداماً. الانفجار الشعري الجنوني الذي يبدو كارثة في المعاينة الأولى، وقد يثير الغضب والسّخط لدى الغيورين على هذا الفن، يقول شيئاً مهماً للغاية، وهو أن علاقة الإنسان باللغة لا تزال تصلح لتعبّر عن وجوده، وهذا فقط ما يعوّل عليه.
عبدالزهرة زكي (شاعر عراقي):
حسناً إذاً؛ قبل سنوات قرر «العالم» أن يحتفل بالشعر، فكرس لذلك يوماً يجري فيه الاحتفال بالشعر، وها نحن، من المحيط إلى الخليج، نحتفل منذ سنوات باليوم ولا نتذكر الشعر.
طبعاً نحن أمة شعر، لكن تاريخنا كان ظالماً لنا، كأمةٍ، لم يقدم هذا التاريخ مثالاً واحداً جرى فيه الاحتفاء بشاعر واحد ما لم يكن هذا الواحد خادماً ويؤلّف شعر خدمات.
ونحن أمة اعتادت على تقديس الموت والموتى، وبهذا اعتدنا إعادة الاعتبار للشعراء وغير الشعراء بعد وفاتهم. إنه شيء من تأنيب الضمير، غير أن هذا الضمير لم يألف طريقةً للاحتفاء. تاريخنا لم يقدم مثالا واحداً عن الاحتفاء وتقاليد الاحتفاء.
ولعل من مساوئ هذا العصر الحديث أنه فتّح أعيننا ووجداننا فوجدنا أن الأمم الأخرى لها شعرها وشعراؤها، وأن لهذه الأمم أساليبها وطرائقها التي تتفنن بها حين تكون بصدد الاحتفاء بالشعر، حتى إن بلداً مثل الولايات المتحدة خصت الشعراء باختيار أحدهم سنوياً ليحظى بتسمية «شاعر أميركا» وليشارك بقصيدة في حفل تنصيب أي رئيس جديد، وطبعاً هذا الشاعر وقصيدته لا يفرض عليهما ولا هما يسعيان إلى تملق الرئيس وتعداد مناقبه، إنه يحضر بامتياز الشاعر على الرئيس.
وفي أميركا وسواها من دول العالم، نجد في كل بلد عشرات الجوائز التي تمنح للشعر والشعراء، بما يجعل حياة الواحد منهم في غنى عن أن يسفح ماء وجهه أمام الآخرين وبضمنهم سلطات دولته.
مبدأ التفرغ للكتابة هو أيضاً شكل من التقدير المشرع إما بقوانين أو بأعراف.
لكن الاحتفاء بالشعراء الموتى هناك لا صلة له بالبكاء والندم، إنه كرنفالات تقام على فراديس أرضية هي قبور الشعراء.. لننظر إلى قبر عمر الخيام، ما دام قريباً منا، وإلى المباهج اليومية التي يعيشها آلاف الزائرين هناك في حضرة الخيّام الذي كان قد عاش حياته برفعة ملك وبهيبة شاعر.
هناك كل أيام الله أيام للشعر.
بينما فرض علينا العالم يوماً واحداً للشعر، وها نحن نحتفل باليوم وما زلنا حتى في هذا اليوم نحتقر الشعر ونزدري الشعراء.
زكي الصدير (شاعر سعودي):
لدي قناعة تكبر يوماً بعد يوم، بوهم أولئك الذين يعتقدون أن الشعر قادر على تغيير العالم على امتداد حضوره الإنساني الذي يقتحم مكامن الخوف والفزع والتشظّي في نفوسنا. إلا أن غربة كبيرة تسكن هذه القناعة. وكأنها ترفض التسليم لي بذلك.
وعلى مدى سنوات في اشتغالي الصحافي، كنت دائماً أبحث في ضمير أصدقائي الشعراء عن إجاباتهم الخاصة حول مدى قدرة الشعر على منع أو ترميم الدمار، لا سيما بعد الخراب الكبير الذي حلّ بالوطن العربي في ربيعه، وهو جزء من خراب إنساني أكبر -كان وما يزال- يطوّق البشرية في حروبها الأبدية التي لم تتوقف منذ الأخوين هابيل وقابيل.
ومع تفاوت رؤى الشعراء حول سؤال الشعر نفسه، إلا أنهم متفقون على هذه الحالة السوداوية التي آل إليها. ولم يعد ممكناً بالنسبة للكثيرين منهم إلا أن يرفعوا شاهد قبره عليه.
رغم ذلك، سيبقى الشعر مثل ذئب يعوي في الصحراء معترضاً على كل مفردات الفوضى، يرصد مستعيناً بثياب اللغة خوفنا ووحدتنا وانعزالنا الكوني ليؤنس الآخرين، وليخبرهم بأن فماً استطاع أن يقول ما يرغب العالم كله في قوله.
وفي ظل هذه القناعة، يجب أن يكون الشاعر مخلصاً للإنسان فقط دون الوقوع في منحدرات السياسة والعنصرية والطائفية والايديولوجية التي -مع الأسف- أصبحت قوتاً للشعراء في زمن الخراب الكبير.
ياسر عبداللطيف (شاعر مصري):
يوم عالمي للشعر، بتوجيه من اليونيسكو أو الأمم المتحدة، كاليوم العالمي للمرأة، ولضحايا التعذيب، وللأيتام. هكذا يُجمع الشعر، عن جدارة مع الفئات الأكثر تضرراً. لم نسمع عن يوم عالمي للسرد، أو لأدب الرحلة، أو لصحافة الجريمة. هكذا، يبدو الشعر فنّاً يتيماً، وكذلك من ضحايا الحروب.
لكن أي شعر تحتفل به الأمم المتحدة؟ هل هو الشعر المرفوض من دور النشر على مستوى العالم (لأنه لا يبيع)، أم هل هو الشعر الذي يذهب بكاتبه إلى المقاصل وحدود السيوف، أم فقط من يذهب بهم إلى السجون؟ أهو الشعر مباشراً ودعائيا وفجاً أوقات الحراك السياسي، أم الشعر حالماً وهامساً ومنكفئا على نفسه أوقات الاستقرار؟ هي على العموم مناسبة مختلقة، لإقامة أمسية هنا، ومهرجان هناك. فيسافر الشعراء لتنفس بعض الهواء، فيما يبدو الشعر حقيقةً، وإن كان قد وجد أصلاً، في مكان آخر، مختبئاً تحت ركام اللغة ووقائع الحياة، جوهرياً، وغامضاً، ومراوغاً.
عبدالله العريمي (شاعر عماني):
أول هدية حب في تاريخ الإنسان، وهو العروة الوثقى بين الحاضر والقديم والسلطة التي شدّت الإنسان لماضيه وجعلته يأخذ مما هو كائن لما كان في فترة ما قبل الإسلام وفجره، ولذلك جاءت السلطة الإلهية لغةً مُعجزةً له مؤيدةً للنبي الكريم إزاء قوم لا يؤمنون سوى باللغة والشعر بشكل خاص، فهو مشعل المعرفة وما يوقظ رائحة الجمال الخفيِّ في السلوك الإنساني.
في غياب الإيمان بالشعر وجمالياته تَغيَّر عالمنا كله ولا يمكن أن يعتدل أمره، ولكن بإمكاننا أن نستعيض بعوالمنا الجمالية الخاصة، وهذا ما ينبغي أن يقوم به الشِّعر المنحاز لصوت الموسيقى لا صوت البنادق، والذي نقيس به المسافة الفاصلة بين انهيار العالم المخيف وأراجيح الأطفال.
مع كل جرح يصبح الشعر لازماً علينا، ربما كي نبرهن لأنفسنا شيوع صحة العالم واعتدال ضغط دمه، أو نزوِّر هذا القول كي ننجو من منطق الألم وحقيقته ونلجأ إلى صناعة عالم جماليّ مضاد له، ولا يزال الشعراء حتى آخر الدهر يواجهون خراب المدن بقصائدهم ويُطلّون على العالم فيبصرونه غابةً تساقطت أوراقها وهاجرت طيورها، غابة ضاق فيها الهواء، وعليهم أن يزيدوا من احتمالات الحياة بالكلمات والانتماء إلى حزب الشمس والمطر، لا أن يتلذذوا بالعتمة والأشباح.
لقد استطاعت الأيديولوجيات أن تَشطر الشاعر وتلفه بالالتباس بالكبير وتُسقط القيمة الحقيقية التي تسكن الشعر والإنسان فتكسَّر بذلك جوهر الحياة والجمال، ولكن البقاء للشعر على أن ندرك أبعاد الجنون والحماقة التي أُصيب بها العالم، ونُبعد الشِّعر عن الوظيفية التي يحاول العالم جرّه إليها ليعود إلى وظيفته الأساسية وهي صناعة الجمال والفرح.
الشعر باقٍ طالما هنالك طفلة تلعب وزهرة تنبت من شقوق صخرة وسماء مفتوحة للعصافير.
الشعر باقٍ طالما هناك ضحكةُ حبيبةٍ لم تُرسم على الورق، وخيطانُ ثوبٍ لم تُكتشف.
الشعر باقٍ ما دام هنالك مساءٌ يلفنا ونهارٌ يُضيئنا، بقاؤه موصول ومتصل بالحياة على الأرض.
إنه الغناء العام والشخصي بصوت مفرد في سماء مفتوحة لجميع العصافير، هذا الكائن اللامرئي الظاهر، والسماوي الأرضي، والجامع لكل الثنائيات، وفوق التعريف، لا يحده زمان أو مكان إنه وسيلتنا لنزيد به سعة الحياة.